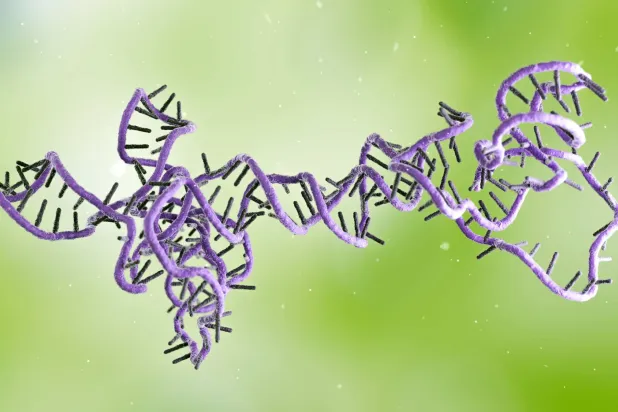لم تسلم باريس اللقب، وإن ادعت أميركا أنها قائدة العالم الحر فإن تمثال الحرية الذي تقع عليه أعين سكان نيويورك مرة واحدة في اليوم، على الأقل، كان هدية من باريس.
في عمله الشهير “أطروحات حول فلسفة التاريخ” يقول والتر بنيامين: ليس هناك وثيقة من الحضارة إلا وهي في الوقت نفسه وثيقة من البربرية”.
كانت الحضارة الغربية تشع أنوارها إلى الداخل والجيوش إلى الخارج. ولم تكن الإبادة التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر بين 1954- 1962 استثناء.
خرجت فرنسا من الحرب العالمية الثانية منهكة، ولكنها بقيت قادرة على “العض”، كما في مراسلات ديغول مع تشرشل. وحتى يدرك حلفاؤها أنها لا تزال قادرة على العيش خارج حدودها، وضبط استقرار مستعمراتها، فقد أبادت ما يزيد عن 8 آلاف قرية جزائرية.
كان الجزائريون الذين يتعرضون للإبادة إرهابيين وعصابات شيطانية تهدد الجزائرين والفرنسيين على السواء. أطلق جيش الاستعمار الفرنسي على نفسه صفة قوات حفظ السلام Force de l’Ordre، مهمتها حماية الجزائرين من الإرهاب، فالجزائر هي فرنسا، كما قالت ملصقات الدعاية آنذاك.
لم تعترف فرنسا المعاصرة بالإبادة، ويبدو أن أفضل ما قدمته في هذا السياق، في 1999، هو الارتقاء بتصنيف الجريمة من “أحداث الجزائر” إلى حرب الجزائر.
في ثلاثينيات القرن الـ19 زار المؤرخ الفرنسي دو توكفيل أميركا، وعلى إثر زيارته كتب عمله الكبير “حول الديمقراطية في أميركا”. مثلت أميركا، في خيال دو توكفيل، النموذج الأكثر اكتمالا للعدالة الاجتماعية، وللحرية.
كمؤرخ كان يعرف أن واشنطن، العاصمة، كانت قبل مائة عام من زيارته لا تزال مستقرا لقبائل Piscataway التي عاشت على ضفاف نهر بوتوماك. الدولة التي صارت مثالا ساميا للعدالة الاجتماعية أخفت أمة بشرية من الوجود. أما كيف فعلت ذلك، وما اتخذته من أساليب وسبل في الجريمة، بما فيها الوسائل البيولوجية، فتعج بها كتب التاريخ.
دعونا نلقِ الضوء على شكل نادر، وحتى صعب التخيل، من الجريمة الاستعمارية بحق الشعوب الأخرى، شعوب الإنسان الأدنى. يساعدنا الماضي على فهم ما يجري الآن، تحديدا في غزة.
ما تفعله إسرائيل- المستعمرة الأوروبية الأخيرة- ينتمي إلى الحقل الاستعماري نفسه، إلى التاريخ والخيال الغربي، بل إلى الغرب في صورته الأكثر بهاء: قديما في عصر الأنوار، وحديثا في زمن الديمقراطية الليبرالية.
في 2009 نشرت مطبوعات جامعة هوبكنز دراسة فائقة الأهمية للباحثة سارة جونسون، حملت الدراسة عنوانا صادما: “أطعموهم رجالا سودا”.
تقصت جونسون تاريخ استخدام المستعمر الأوروبي للكلاب في سبيل إذلال السكان الأصليين. slave-catching strategy غطت الدراسة المستعمرات بين الأميركتين في الفترة بين 1790 و1840، وغطت ثلاثة حقول استعمارية: أحداث الثورة الهاييتية (1791-1803)، حرب المارون الثانية في جامايكا (1795-1796)، وحرب السيمينول الثانية في فلوريدا الإقليمية (1835-1842).
أما العنوان فاقتبسته الباحثة من رسالة الجنرال روشامبو، قائد القوات الفرنسية فيما يعرف اليوم بهاييتي، إلى مساعده دو فيمور في 1803: “أبعث إليك يا قائدي العزيز 28 “كلبا بولدوغا”. هذه التعزيزات ستمكنك من إنهاء عملياتك تماما. لا حاجة لأن أخبرك بأن أي حصص أو نفقات غير مصرح بها لإطعام الكلاب؛ ينبغي أن تطعمهم من أجساد الرجال السود”.
في الأثناء تلك كان رينسفولد، النقيب البريطاني في الفوج الثالث ضمن ما كان يعرف بالهند الغربية، يتحرك بين الأميركتين ويرصد الأفعال الاستعمارية التي قال إنها تجاوزت “حدود الحضارة Civilisation boundries”.
وبالنسبة للباحثة سارة جونسون التي عملت على الدراسة في ضوء الفضيحة الأميركية في سجن أبو غريب في العراق، فإن البحث في ماضي الاستعمار، حيث الأمم العظيمة تهبط إلى مستوى ما دون إنساني وما فوق بربري، يساعدنا في فهم ما نراه الآن، فالاختلاف في حيث الشكل لا الموضوع.
بعد أن ألغت الثورة الفرنسية العبودية، بين 1794-1795، جاء نابليون وقرر استعادتها في المستعمرات الأكثر أهمية للرفاه الفرنسي. في 1803 أرسل قائدا جديدا إلى سانت دومينغو- هاييتي الحالية- وطلب منه إخضاع البرابرة المتعطشين للدماء بكل الوسائل.
اختبر رجاله أول دفعة من الكلاب الكوبية بأن دعوا الناس لمشاهدة العرض، وهناك على منصة عالية جاء نبيل فرنسي بعبد أسود كان يعمل في قصره وربطه على عمود. الكلاب التي دربت مسبقا على لحم الرجال السود، كما سنبين لاحقا، أُطلقت على الرجل المصلوب فراحت تنهشه حتى العظم.
أصاب الهلع الناس الذين حضروا، وبلغ الخوف عظامهم. كان القائد الفرنسي الجديد، القادم من مدينة النور، يريد رؤية تلك اللحظة: الخوف والخضوع. وقد رآها. كانت عروض الافتراس تجري في حضور جمهور، وكان ذلك شرطها الأساسي.
أما كيف تُدرب الكلاب على افتراس الرجال السود دون سواهم فتلك قصة أخرى، يذكرها رينسفولد بتفصيل مذهل.
في البدء تحبس الكلاب في أقفاص وحظائر وتجوع لأيام. في الخارج، على مرأى منها، تنصب تماثيل من الخوص المطلي بالأسود، على هيئة زنجي. أمام أعين الكلاب تحشى تلك التماثيل بلحوم ودماء حيوانية.
عندما يبلغ الجوع بالكلاب حافة الجنون تُفتح الأبواب. تنقض المخلوقات الجائعة على التماثيل وتلتهم ما في جوفها من اللحم والدم.
تعلمت الكلاب أن ما هو أسود هو طعام شهي. يقول رينسفولد في مشاهداته “وبينما كانوا يلتهمون ذلك اللحم الفظيع، كان الحارس وزملاؤه يلاطفونهم ويشجعونهم. وبهذه الوسيلة، كسب الرجال البيض وُد هذه الحيوانات”.
كان المحليون- الذين ينعتون عادة بالبرابرة المتعطشين للدماء- يساقون لمشاهدة العرض والأطفال على الأكتاف. تقدم الباحثة سارة جونسون تحليلا نفسيا لإستراتيجية القمع تلك قائلة “بقدر ما يمكن للمرء أن يفترض أن أكثر المخاوف بدائية لدى الجنس البشري هو أن يُؤكل حيا بواسطة الحيوانات المفترسة، فإن الاستخدام المتعمد للكلاب شبه المستأنسة كأسلحة جعل من الواضح أن الدولة كانت مفترسا رهيبا مستعدا لالتهام اللحم البشري بالوكالة”.
وفي باريس البعيدة كان النور يفيض من شوارعها ومؤسساتها الثقافية، وكان الروائيون والشعراء يعتقدون أنه لا غنى للعالم عن بلادهم. وفيما يبدو فإن “حدود الحضارة” التي شغلت بال النقيب البريطاني رينسفولد هي حدود فرنسا، خارج تلك الحدود ثمة شر محض لا بد من إخضاعه بالوسائل التي تليق به.
لنتذكر أن القوات الفرنسية التي قتلت ما يزيد عن مليون جزائري كانت تسمي نفسها “قوات حفظ السلام”. وبالضرورة، فقد كانت الجيش الأكثر أخلاقية في العالم.
كان اللورد البريطاني ألكاريس، الحاكم الوحشي لجامايكا، يشرف على كتائب الكلاب المتوحشة على بعد أقل من 200 كيلومتر من جاره الفرنسي روشامبو، حاكم هاييتي.
عندما أدرك ألكاريس أن الصراع المسلح بين جيشه والمتمردين المارون، في تسعينيات القرن الـ18، يوشك أن ينزلق إلى حرب استنزاف طويلة المدى، ما قد يؤثر على استقرار المستعمرة الثرية، اتخذ قرارا باستجلاب الكلاب المفترسة من كوبا. المارون هم العبيد الزنوج الذين فروا من الأسر وحقول العبودية وعاشوا حياة حرة في أماكن بعيدة عن سيطرة الرجال البيض. أما الكلمة نفسها، المارون، فأصلها إسباني وتعني الوحشي أو البري.
في السابق، في أوروبا، كانت الكلاب تستخدم في كشف الكمائن والمخابئ، غير أن كولونيالية “عصر الأنوار” اتخذت من الكلاب آلة للقتل. يصف المؤرخ دالاس “R. C. Dalls” في كتابه “تاريخ المارون” الشكل الذي صارت إليه الكلاب المدربة على لحم العبيد قائلا ” تنقض على عنق الإنسان أو أي جزء من جسده، ولا تتركه حتى يُقطع نصفين”.
وهكذا، يقول دالاس، فقد تمكنت الكلاب من وضع حدٍ لحرب ربما كان من الممكن أن تفشل فيها القوة والمهارة العسكرية وحدهما.
لم توفر الظاهرة الاستعمارية من وسيلة للقتل لم تلجأ إليها. مبكرا، في زمن كريستوفر كولومبوس، كانت الكلاب قد دربت على التهام لحوم المقاومين والرافضين الذين كان عليهم أن يعرفوا، على الدوام، أن وضعهم القانوني الصحيح هو في كونهم أدنى من البشر. لنترك المؤرخ والمبشر الإسباني دو لاس كاساس يضعنا في صورة أوروبي آخر، غير البريطاني والفرنسي.
كتب كاساس قائلا: “الطرق الشائعة التي يستخدمها الإسبان، الذين يسمون أنفسهم مسيحيين، لاستئصال تلك الأمم البائسة ومحوها من على وجه الأرض، هي شن حروب ظالمة، وحشية ودامية. ثم، عندما يقتلون جميع أولئك الذين يقاتلون دفاعا عن حياتهم أو هربا من العذابات التي سيتعين عليهم تحملها، يستعبدون من ينجو منهم. وكما قيل، فإن الإسبان يدربون كلابهم الضارية على مهاجمة الهنود وقتلهم وتمزيقهم إربا. ومن المشكوك فيه أن يكون أي إنسان، مسيحيا كان أم غير مسيحي، قد سمع بمثل هذا من قبل”.
الصورة القادمة من غزة لا تحيط بها الكلمات، ومع ذلك فهي تنتمي جذريا إلى الظاهرة الاستعمارية حتى في أفضل نماذجها الأخلاقية.
إسرائيل، الكيان الاستعماري الغربي، تدافع عن وجودها على طريقة الغربيين في مستعمراتهم.
يتفهم النظام الغربي الإبادة في غزة، ويرعاها. هذه ليست مبالغة، فقد تحدثت صحيفة دي تسايت الألمانية، في تقرير مهم منتصف أغسطس/آب الماضي، عن فيديوهات لجنود إسرائيليين ينسفون الأعيان المدنية في غزة، بما فيها المشافي والمدارس، باستخدم أسلحة ألمانية، وأن الحكومة الألمانية على علم بتلك الصور.
اخترت ألمانيا هنا كمثال وحسب، فهي الدولة التي لا تكف عن الزعم أنها تعلمت درسا بليغا من الحرب العالمية الثانية.
أما الساسة والمثقفون الإسرائيليون، فعندما تعجزهم الحجة، حين يجلسون في أستوديوهات التحليل مع إعلاميين أو مثقفين غربيين- من القلة الأخلاقية- فسرعان ما يلجؤون إلى الهراوة التاريخية المثيرة: هل نسيتم تاريخكم؟ ألستم من فعل كذا وكذا؟
إن آلة الإبادة الإسرائيلية، وإن كانت غربية بالمعنى المادي التقني، فهي غربية أيضا على المستويين؛ الأخلاقي والفلسفي. وكما منح الفرنسيون كتائب الإبادة في الجزائر صفة “قوات حفظ السلام”، فالإسرائيليون يرون في قواتهم المسلحة الجيش الأكثر أخلاقية في العالم.
وبالطبع فأميركا، التي خاضت 400 حرب منذ استقلالها، وتعاقب 60 دولة في العالم، هي قائد العالم الحر. والعالم الحر هنا سيفسر على لسان نتنياهو على نحو أكثر دقة “أبناء النور”، مقابل أبناء الظلام. أبناء الظلام، كما يراهم نتنياهو، هم المارون الجدد، أي المتوحشون، البريون، والبرابرة.
وأيا كانت الادعاءات الأخلاقية التي يسبغها الإنسان الأبيض على نفسه، فما من شيء قادر على حبس الحقيقة التي نراها الآن، كما رآها القس الإسباني كاساس قبل 500 عام: و”من المشكوك فيه أن يكون أي إنسان، مسيحيا كان أم غير مسيحي، قد سمع بمثل هذه الجرائم من قبل”.
تختلف أداة الجريمة ويبقى الموضوع. وإن كانت الكلاب وسيلة لإخضاع العدو، ومحوه، قبل مئات السنين، فقد أمكن محو أحياء فلسطينية بكل ساكنيها في وقت أقصر باستخدام قنابل بانكر-باستر، وهي آلة إجرامية تحول العمران إلى فطائر، كما توصف إعلاميا.
أما أطفال هاييتي الذين شاهدوا كلابا مفترسة تأكل جيرانهم، قبل مائتي عام، فقد حل مكانهم أطفال فلسطين الذين سحقتهم برمجية ذكاء اصطناعي أطلقت عليها إسرائيل اسم “أين أبي”!
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة نيوز عربي.