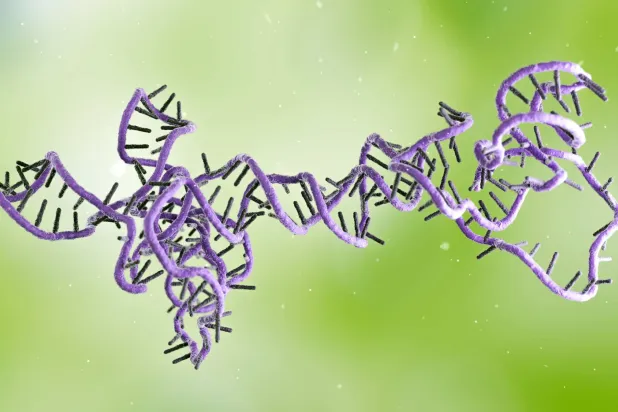منذ ألف عام، قال ابن حزم الأندلسي (ولد في قرطبة عام 994م، وتوفي عام 1064م) في رسائله: “واعلم أن العين تنوب عن الرُسل”.
لكن في حياتنا العصرية، يبدو “التواصل البصري” آخذا في التلاشي، بعد أن أصبحنا في عالم غارق في التواصل اللفظي، والتحديق في الشاشات، والنقر على الهواتف الذكية، “بدلا من التحدث وجها لوجه”. على حد قول محمد طهين، الحاصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، في مقاله الذي نُشر مؤخرا على موقع “ساينس نيوز توداي”.
رغم أن العيون غالبا ما تكون “أول ما نلاحظه” في الشخص، وأحيانا تكون “أكثر ما نتذكره”؛ فهي نافذة الروح التي تُفتح باستمرار، لتنقل المشاعر والنيات والأفكار، حتى عندما تكون أفواهنا صامتة.
كما أن العيون لا تُتيح لنا رؤية العالم فحسب، بل تربطنا أيضا ببعضنا البعض؛ “وسواء كان لونها أزرق أم أخضر أم بُنيا أم عسليا، فالتواصل عبر العين يروي قصة فريدة لروعة العلاقات الإنسانية الجيدة”، كما تقول دافينيا بيفر، زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه بجامعة “بوند” الأسترالية.
التواصل البصري قوة نفسية مؤثرة
يقول الدكتور طهين، عندما تكون جالسا أمام شخص غريب في قطار، وترفع نظرك عن كتابك، فتلتقي عيناك بعينيه لثانية واحدة، فتشعر وكأنك تشاركه شعورا إنسانيا عميقا، هكذا، دون كلمات ولا حتى إيماءات؛ “فتلك اللحظة هي تواصل بصري، بسيط، صامت، لكنه مليء بالمعنى”، إنها واحدة من أقدم أشكال التواصل غير اللفظي وأكثرها شيوعا.
ويضيف طهين أن معظمنا نتعامل مع التواصل البصري باعتباره أمرا روتينيا في حياتنا اليومية، “لدرجة أننا نادرا ما نفكر فيه”. لكن علماء النفس وعلماء الأعصاب والفلاسفة لطالما انبهروا بـ”القوة المذهلة التي تحملها هذه النظرة الثاقبة الناتجة عن التواصل البصري”، فخلف نظرة واحدة يكمن نسيج غني من العاطفة والتواصل والبيولوجيا والثقافة.
ويوضح الدكتور طهين أن عيوننا أكثر من مجرد أدوات للرؤية، فهي “بوابات للألفة، وأسلحة للمواجهة، ومنارات للتعاطف، ومرآة للروح”، ففي كل نظرة، ثمة “قوة نفسية مؤثرة”، قوة تُشكل بهدوء كيفية فهمنا للآخرين، وكيفية فهمهم لنا في المقابل.
لذا، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يُجرون تواصلا بصريا أثناء التحدث، “يُنظر إليهم على أنهم أكثر ذكاء وجدارة بالثقة”، بحسب موقع “نيورولونش”.
التواصل البصري يضيء في أدمغتنا كالألعاب النارية
فور ولادتنا نتعلم التحدث بأعيننا، فنفهم العيون قبل أن نتعلم الكلام بوقت طويل، فالأطفال حديثو الولادة “يبحثون عن الوجوه غريزيا، بعد ساعات من ولادتهم”، وفقا للدكتور طهين.
وقد أظهرت دراسات نُشرت عام 2015، أن “الأطفال الرضع بعمر يومين، يكونون أكثر ميلا للتحديق في الوجوه والعيون، من أي شكل آخر”.
ويوضح طهين أن أدمغتنا “مُتناغمة بدقة” مع أعيننا، وأن القدرة على تمييز العيون وتتبع حركتها، مُبرمجة في بيولوجيتنا، “لمساعدتنا على البقاء”، من خلال منطقة في الدماغ تسمى “التلفيف المغزلي” تتعرف على الوجوه، و”تضيء كالألعاب النارية عندما نُجري اتصالا بصريا”.
وهي التي تجعل من نظرة الطفل إلى عيني أحد والديه “مصافحة عصبية، وتدفقا للأوكسيتوسين (هرمون الحب)، عبر تبادل النظرات، الذي يقوي الروابط ويعزز الأمان العاطفي”.

التواصل البصري رادار عاطفي مذهل
“التواصل البصري لا يقتصر على الرؤية فحسب، بل يتعلق بالشعور”، كما يقول طهين، ويتساءل: هل سبق لك أن دخلت غرفة وشعرت بالتوتر فورا، دون أن تسمع كلمة واحدة؟ أو عرفت أن شخصا ما حزين بمجرد النظر إلى عينيه؟
ثم يجيب مفسرا هذا بأن العين البشرية -على عكس عيون معظم الحيوانات- كبيرة وواضحة بشكل غير عادي، “مما يسمح لها بكشف الكثير”، بسبب اتساع الجزء الأبيض المحيط بالقزحية، الذي يُسهّل متابعة نظرة الشخص الآخر، وفهم ما يلفت انتباهه؛ لذا “يمكننا قياس تركيز شخص ما، وقراءة أفكاره، وحتى تردده، بمجرد النظر إلى عينيه”.
وأكثر من ذلك، تتسرب المشاعر عبر العين، “فالخوف يوسع حدقتي العينين، والسعادة تلين العضلات المحيطة بالعينين لتصنع ابتسامة صادقة، والحزن يكسر النظرة، أما الاهتمام فيزيدها وضوحا”، مما يُشكل عادتنا اللاواعية في “مسح وجوه وعيون الآخرين”، لتفسير المواقف.
فينظر الطفل إلى عيني والديه قبل أن يقرر ما إذا كان الشخص الغريب آمنا، وينظر الطالب إلى وجه المعلم ليرى ما إذا كان سؤاله مقبولا، ويتبادل زوجان نظرة صامتة عبر غرفة مزدحمة ويفهمان بعضهما البعض تماما.
وهكذا، “في كل تفاعل، يقرأ دماغك العيون كالرادار؛ وفي الوقت نفسه، ينقل أحوالك العاطفية للآخرين”.
التواصل البصري ليس دافئا دائما
أحيانا يكون “ساحة معركة لإثبات المكانة الاجتماعية”، ففي التفاعلات البشرية، يشير التواصل البصري المُطوّل إلى القوة، ويمكن أن تمثل النظرة المباشرة تحديا وتأكيدا على الهيمنة، كما يمكن للتحديق المُطوّل أن يُثير عدوانية البشر، وخاصة في المواقف الهرمية أو التنافسية.
يضرب الدكتور طهين مثالا بمقابلة العمل، ففيها إذا قل التواصل البصري، فقد يبدو الشخص متوترا أو مراوغا، وإذا زاد عن حده، فقد يبدو متغطرسا أو متحديا، مما يجعل إيجاد النقطة المُثلى للظهور بثقة، أقرب إلى “لعبة نفسية معقدة” تختلف باختلاف الثقافات.
فما قد يُعتبر نظرة ودية في ثقافة ما، قد يُنظر إليه على أنه عدواني أو غير محترم في ثقافة أخرى؛ ففي العديد من المجتمعات الغربية، يُنظر إلى التواصل البصري المستمر على أنه “صادق وقوي”، ولكن في بعض الثقافات في شرق آسيا وأفريقيا، يُمكن اعتبار التواصل البصري المُطوّل “وقاحة أو عدم احترام”، وخاصة تجاه أصحاب السلطة.
لذا، عندما يجتمع مدير تنفيذي أميركي “يُقدّر” التواصل البصري المباشر، مع نظيره الياباني الذي “يجده غير مريح”، دون فهم هذه الفروق الثقافية الدقيقة، قد يخرج كلا الطرفين بانطباعات خاطئة تماما عن بعضهما البعض.
جودة التواصل البصري ودقته إذن، “رقصة دقيقة، يتطلب إتقانها ممارسة وحساسية للإشارات الاجتماعية”، على حد وصف “نيورولونش”.

ماذا يحدث عند فقدان التواصل البصري؟
وفقا للدكتور طهين، فإن النظر في عيني شخص ما، “هو اعتراف بوجوده وإخباره أنه مهم”. إنها تحية بصرية قصيرة تقول “أراك، وأجدك مثيرا للاهتمام”، أو “أفهمك، وما تقوله يهمني”.
كما يمكن للتواصل البصري أن “يسهم في نجاح أو فشل مسيرتك المهنية”، ففي العديد من ثقافات الأعمال الغربية، يعتبر الحفاظ على التواصل البصري الموزع على جميع الحضور بشكل جيد، بنسبة 60 إلى 70% من الوقت، دليلا على “الثقة والكفاءة والمصداقية”، وكثيرا ما يقال “إن العيون هي مفتاح نجاح مقابلة العمل أو مفاوضات الأعمال”.
في المقابل تُظهر الأبحاث أن “تراجع التواصل البصري يسهم في تنامي مشاعر الوحدة والانفصال”؛ فعندما نتجنب التواصل البصري، فنحن “نُقصّر المسارات العصبية للتعاطف والألفة، ونفتقد التعبيرات الدقيقة والإشارات العاطفية والومضات الصغيرة، التي تُشعرنا بأننا معروفون”.
في الفصول الدراسية وأماكن العمل، قد يشعر الذين يتجنبون التواصل البصري بانخفاض تفاعلهم، وفي العلاقات، يمكن أن يؤدي غياب التواصل البصري إلى تآكل الأمان العاطفي، وفي المجتمع، “يمكن أن يصبح تجنب التواصل البصري، تجنبا للإنسانية”.