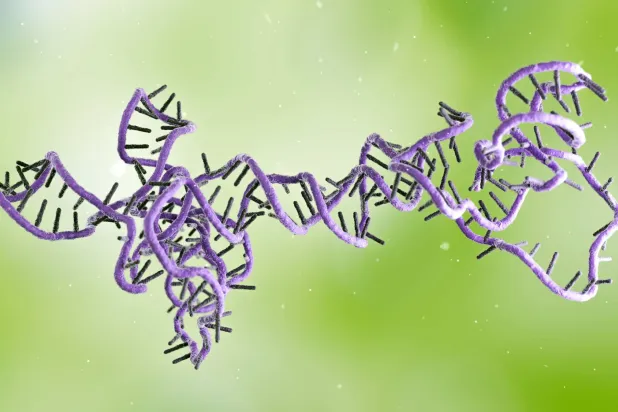قطاع غزة – من بين الركام، وصرخات الموت، والصمت العالمي، تنهض الكلمة من بين الرماد شاهدة على الإبادة. وفي غزة، حيث تقصَف الحقيقة قبل الحجر، وتقتَل الكلمة قبل البشر، يتصدى الأدباء والكتاب للحرب بطريقتهم الخاصة؛ يسجلون، ويكتبون، ويوثقون، لا من أجل ترف الكتابة، بل مقاومةً بالكلمات، وصوتِ الذين انقطعت أصواتهم تحت الأنقاض.
في غزة اليوم، لا تكتَب القصيدة أو القصة أو الرواية للترف، بل لتصبح شاهدًا، وسلاحًا، وحتى كفنًا رمزيًا. والكتّاب هنا لا يكتبون من أجل النشر، بل من أجل النجاة.
وفي عالم يصمت أمام المجازر، تبقى الكلمة الفلسطينية هي الصوت الأخير، والأصدق أمام حقيقة الموت الزؤام. وفي زمن يسوده القتل والتهجير والتعتيم، يصبح القلم أداة بقاء، والكلمة خط الدفاع الأخير.
كثير من كتاب غزة هجرتهم الحرب من منازلهم، لكنهم حملوا معهم دفاترهم وهواتفهم المحمولة، يكتبون على الأرصفة، وفي الملاجئ، أو داخل خيام اللجوء. ورغم كل هذا، لا يدعي الكتاب أنهم أبطال خارقون.
من السخرية إلى الدم
لكل كاتب طريقته في رواية الإبادة والمأساة، فالكاتب الساخر أكرم الصوراني، الذي عودنا على السخرية اللاذعة والضحك من بين رماد الواقع، لم يجد في قاموسه إلا الحزن حين أطبقت الإبادة على غزة. تحولت حروفه، التي كانت تهزأ بالخذلان، إلى كلمات من دم، تنزف على الورق وجعًا لا يحتمل.
الرجل الذي طالما أضحكنا من تناقضات الحياة، والذي اختار الضحك سلاحًا ناعمًا في وجه القهر، لم يستطع أن يضحك هذه المرة، وقال للجزيرة نت:
“حين حلت الإبادة على غزة، تحولت سخريتي إلى غضب، وتحولت ضحكاتي إلى بكاء مكتوم بين الورق.
حروفي، التي كانت تسخر من عجز السياسة، باتت تصرخ من عجز الإنسانية. وكلماتي، التي كانت ترفرف كالعصافير، نزفت دمًا على الأجساد المطحونة، والجثث المحترقة تحت أنقاض البيوت المهدمة، فكتبت:
“في غزة دب انفجار.. دب الحصار.. دب الصوت.. دب الموت.. في غزة دب الرعب والزفت.. في غزة صفّينا على الأسفلت.. في غزة، من في غزة إلا أنت”.
يضيف الصوراني “أصبح الأدب والكتابة المساحة الأكثر وصولا وحرية وتعبيرا، وهي وسيلتنا للنجاة من الحصار والإبادة، ولإيصال صوتنا إلى العالم، رغم خوارزميات القمع والتعتيم”.

في قلب الموت والإبادة
“إن هذا الخيط الرفيع في جسدي بعد كل ولادة قيصرية يذكرني في كل دقيقة بأنني أنجبت ولدا وبنتا وتوأمين رائعين، ثم بقيت وحيدة”.
هذه الكلمات خطَّتها الشاعرة والكاتبة آلاء القطراوي، التي فقدت أربعة من أبنائها: يامن، وكرمل، وتوأمها كنان وأوركيدا، في حرب الإبادة على غزة.
زرناها في مكان نزوحها، وبعد تنهيدة حزينة وطويلة لخصت ما في قلبها من ألم ووجع، وقالت للجزيرة نت:
“لم أتصور يوما أن أكون في قلب الإبادة، بعد أن فقدت أبنائي تحت ركام منزلنا، وأن أكون ضحيتها أو شاهدة عليها وأكتب عنها، بعد أن كنت أكتب للتألق والإبداع وحصد الجوائز.
لقد تحولت كلماتي، التي كانت تنبض بالأمل والحياة، إلى نزيف لا ينضب، وتحولت كتاباتي من محاولة للضوء، إلى صراخ في عتمة لا آخر لها، ومن حروف ترقص فوق الورق، إلى كلمات تتكسر تحت ركام البيوت. أصبحت أكتب لأبقى، لأحصد شهقة نجاة بين قصف وقصف”
واستطردت: “أنا الكاتبة التي كانت تطارد المعاني، صرت المعنى نفسه، معنى الإبادة، والفقد، والضحية، ومعنى الصمود، ومعنى أن تحاول أن تحكي ما لا يحكى”.
كان لها العديد من الكتابات حول الإبادة، منها:
“أفكر كيف يموت المرء لأنه لم يجد ملعقة سكر،
غزة التي حملت جميع احتمالات الموت،
حتى تلك التي لم تطرأ يوما على خيالي الخصب،
الموت قصفا، حرقا، بالرصاص، بالشظايا،
بالقذائف المدفعية، بالكوادكابتر، بالروبوت، بالتعذيب،
لكن هذه الميتة آلمتني جدا، وشعرت أن طعم المرارة يتسع في فمي”.

كتابات على أطلال الرماد والدمار
“في خيمتي تبدو الحياة مقيتة،
والعيش أصبح ميتة أبدية،
وأنا هنالك والخراب يلفّنا،
فمضى التأقلم سنة كونية.
من للمخيم شمسه؟ أقماره؟
رحل الجميع بغارة جوية.
من للديار؟ بكاؤها ودموعها؟
من للديار عيونها البنية؟”
أبيات من قصيدة نثرية في ديوانه بعنوان “خذي ما شئت من ذكراي” للشاعر محمد أبو زريق، الذي اعتبر في تصريحه للجزيرة نت أن الشاعر ابن بيئته وطينة أرضه الطيبة، وأن القصائد مرايا معكوسة للواقع الذي يعيش.
تحدث عن تجربته قائلا:
“قبل الإبادة كنت أنقب عن الفكرة في زقاق المدينة وأحراشها، فألتقط صورة جديدة لم يتطرق إليها شاعر قبلي، ثم أطهوها على نار هادئة لتستوي وتنضج.
أما في تلك الإبادة التي نحيا، فإن الصورة جاهزة، طازجة، أينما وجهت بصرك.
لقد تناقص الوقت الذي كنت أستقطعه من جيوب يومي من أجل الكتابة، وذلك لانشغالي بحمايتي وأفراد عائلتي، وبحثا عن كيس طحين أو شربة ماء، ناهيك عن النزوح إلى اللامكان”.
أضاف: “في زمن الإبادة تغيرت لغتي، وشط نهجي، وأسلوبي الذي كنت أعرَف به؛ فبدلا من كتابة قصيدتي من شرفةٍ مطلة على البحر، وأنا أحتسي قهوتي السمراء، أضحيت أكتبها من نافذة تطل على الرماد”.

وحول أسلوبها في وصف الإبادة، قالت الشاعرة والكاتبة كفاح الغصين للجزيرة نت: “منذ أن اشتدت الإبادة، سابقت الوقت لنثر ما أستطيع من لغة بهيئاتها المختلفة، لأنجب منها ديوان هكذا الحرب، الذي ينتظر الطباعة. تحدثت فيه عن ويلات الحرب، عن الوجع، عن الجوع، عن الحلم، عن الأمل، عن الموت والحياة”.
وأضافت: “كتبت على أطلال الرماد بقلب أنهكه الموت، وبعثرته الحرب، بروح مزقتها السلوكيات الهمجية للمحتل، وبوجدان أثقله الدمار، والنزوح، والاغتراب المر، في إبادة قادتنا نحو قبورها ضحايا لمحتل فاق في همجيته وعنتريته التتار والمغول، وعتاولة الإجرام”.

تدوينات بلغة الناجين
ولقد وثق الكاتب والأديب حسن القطراوي، صاحب رواية لغة آدم، الإبادة بطريقته الخاصة، فقد كتب عنها عبر صفحاته على فيسبوك وإنستغرام:
“أحدث نفسي قبل كل بوست: ما الذي يمكن أن نقوله عن حالنا ولا يعرفه الناس؟
غزة تسبح في أوجاعها منذ عامين تقريبا ولا نهاية.
كل شيء يتكرر، ولا شيء يتغير. الموت نفسه، بل يزداد شراسة، الجوع ينتشر ويكبر، الحزن يتضخم كالمرض الخبيث، لا شيء يتغير!
العالم كله يعرف، ويمضي! يمضي، تاركا خلفه شعبا بأكمله ينزف، صدقوني؛ شعب بأكمله ينزف!”
“لم يعد القتل الفردي ميزانا لضمير العالم.
نحن مجرد عشرات.
وقوف القتلى عند الرقم 100 مقبول نسبيا.
لا يريدون موتا مزعجا ومحرجا، بل يريدونه هادئا، مكتوم الصوت”.
وفي حديثه للجزيرة نت قال “لا شك أن حرب الإبادة على غزة نزعت الدهشة من كلماتي، وجعلتها أكثر صدقا وقربا من الواقع. صارت اللغة أكثر عُريًا. لم أعد أكتب لأبهر، بل لأشهد. لا يمكن أن تعيش الإبادة وتبقى لغتك وأسلوبك كما هما؛ بقاء لغتك وأسلوبك كما هما يعني أنك لم تتغير ولم تشعر، سيما أن الكتابة إحساس أصلا”.
“في الإبادة، صارت لغتي حادة، وعارية، وموجعة، لم تعد تحتمل التجميل أو المواربة. صرت أكتب بلغة الناجين، بلغة من يعرف أن كل جملة قد تكون الأخيرة. أراها وسيلة للبقاء أولا في زمن الإبادة. الكتابة تعيد لي صوتي في عالم يريدنا صامتين. كل كلمة نكتبها هي وثيقة نجاة مؤقتة”.
وأضاف: “الأدب هو التوثيق الحقيقي للأجيال، لأنه يقرأ بالروح، بالإحساس، بالمشاعر. الأدب هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها نقل الحقائق للأجيال، فتصل خضراء ندية، لأنه فقط من ينجو من رغبة الأقوياء في محو الذاكرة أو قتلها. فهو لا يوثق ما يحدث فقط، بل كيف حدث”.

شاهد عيان.. فقط في غزة
وفي خضم هذه الأحداث، يبرز الصوت الأدبي كصوت متمرد ينزف بالحبر، بالوجع، وتظهر الكتابات الأدبية في توثيق الإبادة على غزة كنزف مستمر على الورق. الكاتبة والصحفية رشا فرحات تروي للجزيرة نت عن تجربتها في توثيق الإبادة، قائلة:
“تغيرت طريقتي وتغير أسلوبي، فالكتابة في زمن الإبادة ليست كقبلها، والقلم في يدي أصبح أداة للبوح والصراخ، بل خنجرا يغوص في خاصرة الظلم والقهر والعذاب.
في غزة، أصبحت كلماتي تنتزع من بين الركام، من صراخ الأمهات، من نظرات الأطفال الذين كبروا فجأة وهم يحملون نعوش أحبتهم”.
“إذا كان لا بد أن أموت، فلا بد أن تعيش أنت لتروي قصتي”.
عبارة للشهيد الدكتور رفعت العرعير، أستاذ اللغة الإنجليزية في الجامعة الإسلامية، الذي كان شاهدا على الإبادة بدمه، عندما اغتالته الطائرات الإسرائيلية، وقد وثقتها فرحات على غلاف قصتها “شاهد عيان.. فقط في غزة”، والتي تتحدث فيها عن الموت بأبشع صوره في غزة، حينما سطرت: “لم تعد الكتابة ترفا ولا خيارا، بل صارت فعل نجاة، تنفسا أخيرا في غرفة تغرق بالدخان”.
وقالت “الإبادة المستمرة في غزة جعلت الكتابة أكثر إلحاحا، أكثر صدقا، وأكثر نزفا. أكتب من داخل الجرح، لا من خارجه. لم تعد النصوص تحتمل الزينة، بل تتعرى من كل زخرف، وتصرخ كما تصرخ الأمهات عند المقابر الجماعية”.
وأضافت فرحات “لقد تغيرت لغتي، فباتت أكثر اختزالا، كأنها تحاول اللحاق بنبض متسارع. الكتابة في زمن الحرب تشبه الكتابة من داخل الخندق، لا وقت للتأمل الطويل، ولا مكان للمجاز الزائد، حتى الاستعارات صارت ثقيلة”.
“كل شيء صار مباشرا، حادا، كما لو أن الكلمات نفسها فقدت جلدها. كل حرف كتبته كان قطعة من قلبي تنتزع لتزرع في تراب الحكاية، علّها تنبت يوما عدالة. أنا لم أكن مجرد شاهدة على المجزرة والإبادة، بل كنت جسدا داخلها، أتنفس الدخان، وأرتق الجراح بالكلمات. أدبي في هذه الإبادة ليس ترفا، بل مقاومة، نبضا في زمن الموات، ورفضا لأن يكتب تاريخ غزة بلغة القتلة”.